” نازك وزين الدار”.. قصة قصيرة للكاتب اللواء حمدي البطران
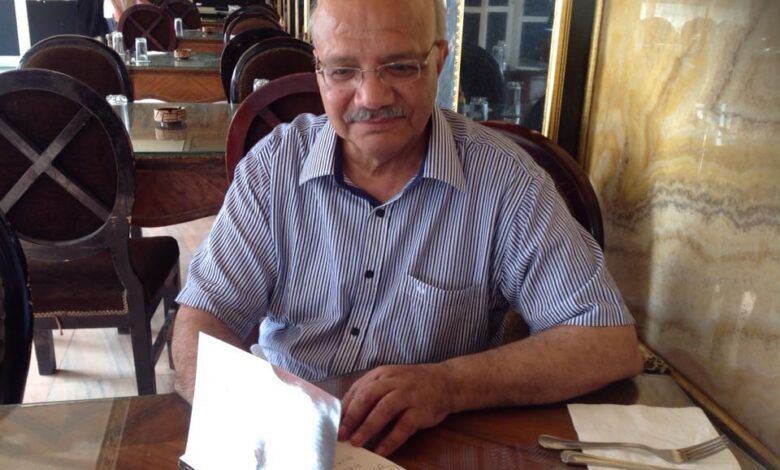
” نازك وزين الدار قصة قصيرة من المجموعة القصصية ” بئر أم السعد” للكاتب الكبير اللواء حمدى البطران، الذي صدر له العديد من الأعمال الأدبية، والتي جاء نص القصة القصيرة كالتالي:
عدت إلى بيتي منهكا بعد عمل يوم طويل وممل، فقد غدت المحاكم لا ضابط لها، بعد أن انهار الأمن، كما أرهقني المحامون بمرافعاتهم وطلباتهم، استقبلتني زوجتي نازك متهللة. لم تنتظر حتى أخلع ملابسي وقالت:
– حركة المحافظين باكر، مكتب رئيس الوزراء أتصل بالرقم الأرضي القديم.
. . .
لم يكن كلام نازك جديدا عليَّ، كنت أعرف، لأنني دعيت لمقابلة أحد رجال المجلس العسكري، وطلب مشورتي في تعديل قانون البلطجة، كانوا يتصلون بي دوما، ودعيت مرات عدية إلى جلسات عمل مكثفة معهم، كما أن وزير العدل سألني مرات عديدة عما إذا كنت راغبا في العمل السياسي العام، وأخبرته أنني لا أرغب في الابتعاد عن منصة القضاء، ولكن الوزير أخبرني باسما أنه أملى اسمي في مكتب رئيس الوزراء، باعتباري من المرشحين للمناصب الإدارية العليا.
في هذا اليوم كانت نازك منتشيه، وعندما فرغنا من تناول الغذاء أخبرتني عرضا أن فلاحة من الصعيد جاءت للسؤال عني، وأنها – إي نازك – أخبرتها أنني سأعود في آخر اليوم، وقالت بامتعاض أنها ربما تأتي.
لم أهتم بالأمر.
. . .
لسبب مبهم وغامض، لم تكن نازك ترحب بمن يزورني من أهلي من الصعيد، فهي لا تهتم بهم، ولا تريدهم، وتقابلهم بجفاء متعمد.
لم يكن هذا جديدا على نازك، تعودت هذا منها منذ زمن بعيد، ولم أغضب، واعتبرت أنها واحدة من نقائض النساء عموما، فكل امرأة لها جانبها السيئ في علاقتها بزوجها، وكان هذا هو فقط جانبها السيئ في علاقتنا الزوجية، كانت تكره أهلي!
. . .
بعد أن شربت الشاي ذهبت إلى حجرتي، لكل منا حجرته المنفصلة منذ أن تزوجنا، كان هذا طلبها منذ السنة الأولي لزواجنا، استلقيت على السرير.
في هذا اليوم بالذات، لم يأت النوم كالمعتاد.
لم أسترح للهجة نازك في الحديث عن أهلي وأقاربي من الصعيد. يبدو أنها لاحظت، لأنها دخلت غرفتي الآن، لتخبرني أنها ستجلس في الصالة لأجل أن تسمع نشرة السادسة. وقالت مبتسمة:
– أنا متأكدة من اتصالهم بك.
ثم خرجت وسحبت الباب خلفها، وتركتني ممددا على السرير.
. . .
عندما تخرجت من كلية حقوق القاهرة كنت من الأوائل على دفعتي، وبعد ثلاثة شهور جاءني خطاب ترشيح من مكتب النائب العام، وعرفت أنني سألتحق بالنيابة العامة، كان هذا في مطلع السبعينات. فرح أبي فرحا غامرا، وعمت الفرحة كل عائلتنا وقريتنا.
فرحت بعملي في النيابة العامة، وكان عملي في القاهرة، وقتها كانت هواية الكتابة في مراحلها الولي وكنت في أوقات فراغي أتردد على نادي القصة في القصر العيني، وهناك تعرفت على محمد جبريل وفؤاد قنديل وعبد العال الحمامصي ويوسف الشاروني ورءوف مسعد ويوسف القعيد وصنع الله إبراهيم وسيد الوكيل وغيرهم.
وبعد عامين من العمل. كان رئيسي في العمل، يوكل إلى البلاغات التي تسبب الحرج لزملائي من أهل القاهرة. كان الرجل يعرف طبعي، فأنا لا أستجيب لوساطة أحد، فأنا كصعيدي في القاهرة لا أعرف أحد هنا، ولا يعرفني أحد. وقد سمعته أكثر من مرة يصفني بأنني صارم. والحق أنني كنت أطبق القانون.
كنت في تلك الفترة أقضي أجازاني في قريتي في الصعيد، وصارحت أبي برغبتي في الاقتران بزين الدار!
كانت زين الدار قريبتي من ناحية أمي، تربينا معا في سنوات الصبي الأولى في الإعدادية، وبداية المرحلة الثانوية، كانت زين الدار جميلة وطويلة، صافية الوجه، واسعة العينين. وكانت تشبه إلى حد كبير ممثلة السينما الإيطالية صوفيا لورين. كانت طويلة مثلها، ولها نفس تقاطيعها الجميلة.
أمي رفضت فكرة زواجي من زين الدار التي أحببتها، وانحاز إليها أبي في رفضها الجائر!
كانت زين الدار تأتي كل صباح إلى الساحة الواسعة أمام منزلنا , وعلى رأسها صفيحة فارغة , تضعها في حوض الطلمبة – أم يد – وتبدأ في الانحناء على يد الطلمبة الحديدية الملتوية, كان نصفها الأعلى يعلو ويهبط , وهي تحرك يد الطلمبة , لتخرج الماء من جوف الأرض, وكانت المياه تنساب في الصفيحة من فم الطلمبة , الذي يشبه جمجمة الكلب, كان سقوط المياه في قعر الصفيحة الفارغة يحدث صوتا, وكان هذا الصوت ينبئ عن وصولها, عندها أنزل من حجرتي في البيت, إلى الساحة التي فيها الطلمبة, تكون زين الدار هناك بمفردها , أسرع إليها , وامسك عنها يد الطلمبة الحديدية , أرفعها وأخفضها بعنف حتى تمتلئ صفيحتها , كانت ترمقني طوال الوقت الذي تمتلئ فيه الصفيحة , لم تكن عيني تبتعد عنها أثناء حركة جسدي لأعلي وأسفل عند تشغيل الطلمبة . كنت اشعر بخدر لذيذ يجتاحني، متسللا من ظهري حتى يشمل كل جسدي، كانت الصفيحة تمتلئ ببطيء، وأعيننا متشابكة، ولا ننتبه – لفرط استغراقنا في المتعة – إلى الصفيحة التي امتلأت وسال الماء على جانبيها. وتنحني زين الدار على الصفيحة، تحاول رفعها على رأسها بمفردها، عيناها ترمقاني، وكنت من فرط استغراقي فيها، لا أفطن إلى أنها تريد أن ترفع الصفيحة، وأنها لا تقدر على رفعها بمفردها، وأفيق على صوتها الحالم: ارفع الصفيحة معي.
كنت أقترب منها وهي تنحني لتمسك الصفيحة لنرفعها معا، وكان ثوبها ينحسر عن صدرها الناهد، في طور تكوينه الأول، وكنت أرتبك وهي تضع يدها تستره، وألمح في عينيها انتصار من نوع غامض، وأرفع معها الصفيحة الثقيلة حتى تستقر على رأسها، كانت تبتسم وتنظر بعيدا عنى، ثم تبتعد، وكنت أرقبها وهي تنصرف حاملة الصفيحة على رأسها.
كنا يوميا نمارس حبنا المكتوب بالنظرات فقط، مرة حاولت تقبيلها، قدمت لي شفتيها، ثم أغمضت عينيها، وضبطتنا ام ممدوح جارتنا.
بعدها اختفت زين الدار. ولم تحضر أبدا إلى ساحة بيتنا لتملأ الصفيحة، جاءت أمها بدلا منها.
وقتها شعرت بلوعة فراقها، تعلقت بعينيها ونظراتها، كانت قبلتها الوحيدة حافزا لي على التفوق، كنا نلتقي صدفة وخلسة، فنتبادل النظرات صامتين، وكنت أهم بالكلام معها وكانت تبتسم، وقلت لها: أنتظريني.
وانتظرتني زين الدار، ورفضت آخرين تقدموا إليها.
عندما عينت في النيابة، أخبرت أمي برغبتي في الاقتران بزين الدار، ورفضت أمي بعنف، أخبرت بدورها أبي الذي رفض الفكرة. سافرت أنا إلى القاهرة محملا بحب زين الدار وشجن فراقها، وبعهدها سمعت أن زين الدار خطبها أحد أقاربي، وانقطعت أخبارها عني تماما.
. . .
تعرفت على نازك في نادي القصة. وقتها كنت أقرأ قصة قصيرة، كانت تحضر مع الهواة والكتاب المبتدئين، بعد ان قرأت قصتي الأولي، اكتشفت أنها تركز عينيها على وأنا أقرأ. تركيز عينيها أربكني، تلعثمت. ولكنني نجحت في قراءة قصتي، وتلقيت تعليقات نبيل عبد الحميد وفاروق عبد الله، وانتهت الندوة، وبينما أنا أجمع أوراقي، كانت تجلس بمفردها في القاعة، وكانت نظراتها لا تزال مسددة على، ثم نهضت قائمة، واقتربت مني، وقالت:
– قصتك جيدة، لهجتك الصعيدية زادتها جمالا، كأنك تقرأ قصيدة شعر.
لم أكن في أحسن حالاتي. ولم أجد عندي – لفرط ارتباكي – ما أرد به عليها. مضت فترة من الصمت، لم أقدر خلالها على الكلام، كانت نظراتها تقتحمني وتربكني.
للمرة الأولي أشعر بالانهيار أمام أنثي، كانت أول أنثي تكلمني بعد زين الدار. لم تكن أنثي عادية، كانت النموذج المثالي لأنثى أبحث عنها. كانت تبتسم ابتسامة صافية، لونها أبيض يشوبه احمرار لذيذ. شعرها يلمع كالذهب، وجهها مستدير. عيناها فيهما جمال نادر.
رغم ارتباكي، شكرتها.
نزلنا معا، سرنا دون كلام، قالت وهي تزيح خصلة جميلة من الشعر عن عينيها:
– أنت مدرس؟
قلت:
– وكيل نيابة.
صاحت برقة تلقائية:
– وكيل نيابة؟
كنت مبتهجا وممتنا، غمرتني حالة من النشوة لم اعهدها من قبل، وكنت غير قادر على جمع شتات نفسي، ووجدت نفسي أسألها:
– وأنتِ؟
أخبرتني أنها خريجة آداب إنجليزي، وأنها تقوم بأعمال الترجمة لصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية، سرنا معا أنا وهي. تجولنا في شوارع جاردن سيتي، استرسلنا معا في حوار لا زلت أذكر كل تفاصيله، وكانت نهايته أن أعطتني تلفون بيتها، وأعطيتها تليفون الاستراحة التي أقيم فيها.
توقفت أمام منزل كبير له باب ضخم وأشجار عتيقة بداخله، واستأذنت مني، ثم غابت فيه، راقبتها وهي تصعد السلم العريض، وأشارت إلى مودعة. وما أن أعدت إلى الاستراحة حتى تناولت التليفون، قضينا ساعات طويلة نتحدث.
. . .
الحق أن نازك فتحت أمامي أفاقا رحبة لعلاقة لم تكن متوقعة ولم أكن أحلم بها.
في البداية طلبت مني نازك أن أطلق شعري وأجعله طويلا، أشارت إلى صالون حلاقة، وطلبت مني أن أهذب شعري فيه، وابتسمت وهمست باللغة الإنجليزية:
– ريموف يور موستاش.
لم أفهم في أول الأمر، ولكنها كررتها ببطئ وإصرار، وأشارت إلى شفتها العليا. أخيره فهمت.
ووجدت نفسي أطلب من الحلاق حلاقة شاربي، وأن يترك لي سوالف أعلي صدغي.
صحيح أنني عانيت من سخرية زملائي، ونظرات الدهشة على وجوه الحجاب والكتبة، إلا أنني لم يكن يعنيني سوي نازك.
وبعدها اقترحت على نازك أن نذهب معا إلى محلات الصالون الأخضر، وهناك أختارك لي قمصانا ملونة لها ياقة عريضة (فان هاوزن) , وسراويل نهاية أرجلها واسعة (شارلستون).
كما صاحبتني إلى دور السينما، وإلى ندوات مقهى ريش، وقهوة الفيشاوي، وقاعات الموسيقي، والملحقيات الثقافية لبعض السفارات.
وأخبرتني نازك أن والدها كان من رجال الصف الثاني لثورة يوليو. وكان قبل أن يتوفى مديرا لبنك كبير، وأن معظم أفراد عائلتها يعملون في السلك الدبلوماسي والقنصلي، وخالها وابن عمها سفراء. وأنها ووالدتها تمتلكان عمارات في المنيرة وشبرا والدقي، والدها ترك لوالدتها أموالا سائلة كثيرة، وقطعا من أراضي البناء في مدينة نصر ومصر الجديدة. كما عرفت أنها تقيم مع أمها وأختها الكبرى في القصر الذي شاهدتها تدخل فيه أول يوم تعارفنا، كان أحد القصور الرصينة في جاردن سيتي.
تعودنا أن نلتقي يوميا.
اليوم الذي لا أراها، أصبح متوترا وحرونا.
وجدت نفسي أباعد بين زياراتي لأهلي في الصعيد، لأجل ألا أبتعد عنها. شيئا فشيئا أصبحت نازك جزء من برنامجي اليومي، بعد انتهاء عملي وفي يوم راحتي، كانت فكرة الاقتران بها تبدو بعيدة، غير أنني ذات مرة صارحتها برغبتي تلك.
ابتسمت نازك، ولم ترد.
عندما سافرت إلى بلدتنا، أخبرت أبي بأنني سأتزوج من القاهرة. لم يمانع. سألني عن أنسبائي الجدد. أخبرته بما أعرفه عن نازك، تولت نازك الأمر مع أهلها، لم يسألوا عن أهلي.
في يوم الزفاف كان الضيوف كثيرون، ومعظمهم من كبار المسئولين. وزراء وسفراء ورجال أعمال وحكام. وكانت نازك تشير إلى كل واحد منهم وتعرفني بوظيفته، كان أبي وأشقائي وأزواج شقيقاتي يرتدون الملابس البلدية والعباءات. إلا أنهم جلسوا معا في ركن قاعة الحفل كالغرباء.
لم أشعر بأهلي عندما غادروا الحفل ليلحقوا بقطار الليل.
بعد أسبوع جاءت أمي وشقيقاتي وزوجات أشقائي وأخوتي البنات وأزواجهن، جاءت بهم سيارة ميكروباص أنزلتهم أمام باب القصر، عندما نزلوا حملت النسوة السلال على رؤوسهن، وعندما دخلن القصر أطلقن الزغاريد، لم ترحب بهن نازك، وتجاهلتهن!
قضين ليلتهن، ومع مطلع الصباح غادروا.
لم تحضر أمي مرة ثانية.
. . .
دخلت إلى عالم نازك المخملي الناعم.
في أسبوع الزفاف وصلتنا دعوة من خالها للسفر إلى أسبانيا في باخرة، ومن أسبانيا برا إلى فرنسا. وكانت تكاليف الرحلة كلها مدفوعة مقدما.
بعد عودتنا من الرحلة، بدأت نازك تملي تعليماتها، لا زيارات لأقاربي إلا بموعد سابق، وألا يبيتوا معنا، ولا يتكلموا بصوت عال، وأن يخلعوا احذيتهم عند باب القصر، ولا كلام أمام الخدم، ولا، ولا…
أمام حبي الجارف لإنوثتها، والاحترام الذي لقيته من عائلتها الأرستقراطية والعريقة، غفرت لها تكبرها وصلافتها!
مضت حياتنا ناعمة وجميلة، كانت نازك خلالها ناعمة ومتجددة، لم يكن يعكر صفوها إلا عدم إنجابنا، لم يشغلني ذلك.
. . .
كنت لا أزال أستلقي على السرير، لم أتمكن من الإغفاء بعد العصر.
سمعت جرس الباب الخارجي.
فتحت نازك الباب. سمعتها تقول بحدة:
– اخلعي الحذاء وأدخلي.
خرجت من حجرتي، وذهبت إليها، كانت امرأة صعيدية تجلس على السجادة.
سيدة في الخمسين ترتدي جلباب أسود، وتضع على رأسها شالا أسود، وكانت حافية.
عندما رأتني، نهضت واقفة، تناولت يدي وقبلتها.
زين الدار!
لم ترفع عينها عني. وخرجت منها ابتسامة عفوية. وقالت:
– إزيك يا محمود.
أخذتني المفاجأة، لم أرد.
طويلة وجميلة كما كانت، وجهها تخللته بقع سوداء، عيناها واسعتان كما كانتا، فقط أحاطهما السواد، قدمها أصبحت خشنة، نفس فتحة الفم المستديرة. شفاهها ذابلة، تكسوهما طبقة من القشور، ومع ذلك بدت تقاسيمها جميلة، رصينة، مبهجة، تفح بالرغبة، أنوثتها كما هي، واضحة المعالم، باسمه. بدا شعرها الأسود الناعم يطل من تحت غطاء رأسها الأسود القديم، تتخلله خصلات بيض. وكان جلبابها الأسود الباهت يلف جسدها الممشوق. نظرتها الجريئة انطفأت. وحلت محلها نظرة كابية خجلي حتى وهي تبتسم.
نظرت إلى الخارج، وقالت:
– زوجتك؟
أومأت إليها.
مرت لحظة صمت، كانت زين الدار تقارن نفسها بها. قلت:
– كيف حالك يا زين الدار؟
قالت:
– عايشين، ابني يا محمود، مبيض محارة. غائب من شهر.
ثم نهضت من جلستها، وخطفت يدي وقبلتها، واستطردت باكية:
– أنت سوف تدلني عليه. أخوتك منعوا عني عنوانك، لكن أنا عرفت أوصل لك، أولاد الحلال أعطوني العنوان.
أجلستها على الكرسي.
تمنيت أن أحضنها وأقبلها.
جلست وهي تنظر إلى الأرض.
كان ابنها غائب، وهي لا تعرف عنه شيء، طافت بالمراكز والأقسام والمستشفيات ولكنها لم تعثر له على أثر، كانت تبكي خلال كلامها.
طلبت أحد زملائي من أعضاء النيابة. أعطيته الاسم. أمهلني دقائق.
في تلك اللحظة، دخلت نازك مندفعة. وقالت مبتهجة:
– مبروك يا محمود، الرئاسة اتصلت، أصبحت محافظا. ستحلف اليمين غدا، البدلة جاهزة
كانت زين الدار تنظر إليها مستغربة.
نظرت نازك إلى زين الدار. وقالت:
– مجيئك فال حسن. في زيارتك القادمة سيحلف محمود يمين الوزارة.
ثم ناولتها بضعة أوراق مالية كانت في يدها، وسحبتها إلى الخارج.
أتصل بي زميلي الذي تكلمت معه وقال: وجدناه، راقدا في المشرحة منذ خمسة عشر يوما. قناص أصاب رأسه. إذا كنت تعرف أهله، أرسلهم.
أشفقت على زين الدار من قسوة الخبر. لم أشأ أن أخبره، سحبتها من يدها، وخرجت معها.




